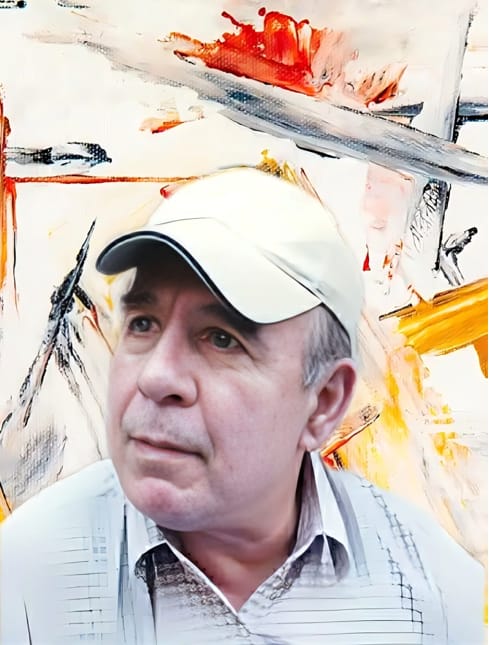
نعتني بخصائص النصّ، وعندما يكون التشفير من المهام اللغوية، فالدلالات التي نقصدها يتراوح تفعيلها بين اللغة والمعنى، وبين تشفير اللغة ومفاهيمها، فالتغييرات التي تحدث، تعتلي السلم التدريجي للمفاهيم النصّية، ومن هنا تبدأ حركية اللغة باتجاه المتاح، والمتاح الذي نقصده، هو ما يتعلق بالنصّ الشعري من لغاتٍ تواصليّة ولغاتٍ تموضعيّة بعلاقاتٍ دلاليّة؛ حيث يكون الرابط التركيبي، رابطاً دلاليّاً، وفي الوقت نفسه عندما نكون في هذه المنطلقة كيف نبدأ؛ هل من الدال أم من المدلول؟ وعندما نغوص في هذا المنحى نجد أنّهم أكّدوا على أنّ العلاقة بين الدال والمدلول، هي علاقة تطابقـيّة، وهذا ما يقودنا إلى لغة الأشياء، فعند سماع الكلمة نتوصّل إلى دلالتها(1)؛ ولكن هذا لا يكفي عندما يكون التفكر اللغوي خارج لغة الأشياء، مثلاً التموضع اللغوي – الدلاليّ، حيث يتمّ الاعتماد على حركة اللغة من خلال الأفعال، والتي تساهم في تنشيط النصّ من جهة، وتساعد على تحريكه من جهة أخرى، ومن الطبيعي أنّ كلّ فعل يحوي على معنى دلالي، فتكون العلاقة بين اللغة والنصّ علاقة فلسفيّة؛ فهناك مستويات معرفيّة تجانس اللغة النصّية من الناحية الفنّية؛ وهي كما حدّدها ابن رشد: الحسّية منها، والحدسيّة، والكيانيّة، ومن خلال مصطلح الجوهر بالذات(2). ويوصلنا القول إلى أنّ العلاقة بين (الدال والمدلول) هي المفتاح الأساسيّ في فهم المعاني وبناء الفهم والاستدلال في فلسفة اللغة حسب ما اتفق عليه الفلاسفة.
لا يتخلّى القطب اللغويّ في اللغة الشعرية عن القطب الجمالي، فالأوّل هو النسيج التفاعليّ مع النصّ، وهو المنتوج المحقق والمتطابق مع اللغة تماماً في إنتاج النصّ، لذلك تكون المعادلة بشكل أوّلي:
لغة الإبداع الجمالي + الخلق النصّي = النصّ المكتوب.
إنّ وظائف اللغة كثيرة فضلاً عن تعدّدها من قبل رومان جاكبسون (1896 – 1982)؛ ومنها: العاطفيّة والإقناعيّة والشعريّة والانفعاليّة... إلخ. وتبقى رسالة الباث (الشاعر) تختلف عن التعدّديّة التي يلاحقها بعض الكتاب والشعراء، فالرسالة التي يعنيها الشاعر تعتمد التشفير، ولكي يكون المتلقي مع هذه الرسالة فإنّه يستطيع أن يفكّ شيفرات النصّ من خلال متابعته أوّلا وثقافته الشعريّة – النصّية ثانياً؛ ويعد المتلقي أداة من أدوات النصّ، لذلك يكون الإجراء، هو إجراء أستطيقي مثير للجدل اللغوي، حيث أنّ النظام النصّي، هو أسلوب الشاعر، ويعد الأسلوب متعلقا بعناصر النصّ وهو أقرب إجراء وقائي لظهور الدلالات السياقية.
ذهب "هيالمساليف إلى أنّ الأسلوب يمكن أن يحدّد من زاوية علاقة الألفاظ بالأشياء، كما يحدّد أيضاً من خلال روابط الألفاظ بعضها ببعض، وكذلك من خلال علاقة مجموع الألفاظ بجملة الجهاز اللغوي الذي تتنزّل فيه، فالأسلوب في نفسه دال يستند إلى نظام إبلاغي متصل بعلم دلالات السياق، أمّا مدلول ذلك الدال، فهو ما يحدث لدى القارئ من انفعالات جمالية تصحب إدراكه للأرسال(3).
قطرة ُ
الماء ِ
في
سطح ِ
الموجة ِ
لا يعلوها الطوفان ...
*
في التفاصيل ِ
لا يكمن ُ الشيطان ُ
يكمن ُ السّر ...
*
مهما
كان َ البحر ُ واسعا ً..
الوردة ُ لا تنتظر ُ غير َ الندى ...
من قصيدة: قناعات – ص 12 – كتاب (النزهات).
جلّ ما يسعى إليه الشاعر هو أن يصل إلى الفعل الحركي النصّي (الشعريّ) وهو يمثل الثقل الشعري وذلك عن طريق العلاقات النصّية من جهة، ولغة الاختلاف والصور الشعريّة الحركيّة من جهة أخرى، وهي تمثل القوى المحوريّة في المنظور النصّي لدى الشاعر الخزعلي. إنّ العبارة المرنة – التوضيحية تشكّل النزول إلى عبقريّة التواصل وزرع المسافة بين الباث والمتلقي.
قطرة ُ + الماء ِ + في + سطح ِ + الموجة ِ + لا يعلوها الطوفان ...
في التفاصيل ِ + لا يكمن ُ الشيطان ُ + يكمن ُ السّر ...
مهما + كان َ البحر ُ واسعاً.. + الوردة ُ لا تنتظر ُ غير َ الندى...
يتواصل الشاعر مع التقطيع النصّي، وهو الأسلوب التكويني لمقاطع نصّية تكوّن حالتها خارج الهندسة المرصودة، فتارة تكون الجمل مطرية وتارة متقطعة ويتمّ إكمال المعاني بانتهاء النصّ، أو رسم نقطة أو نقاط استرسالية؛ ويدخل التنغيم النصّي كثمرة جمالية لتغذية النصّ. (وقد عني نقاد الشعر بالصوت، من حيث كونه طاقة يمكن استثمارها جمالياً لصنع النغم الشعري وطاقاته الإيحائية الفاعلة والمؤثرة في نفسيات المتقبلين)(4).
يقودنا الشاعر من خلال الوظيفة التخييلية إلى دلالة القصد، وهو يضعنا تارة على ظهر موجة، كي يوظف التشبيه، وتارة أخرى يدخلنا إلى ما يشبه الحكمة برصد عامل الشرّ والذي رمز له بالـ (الشيطان)؛ ولكن من خلال مقوّمات الطبيعة يميل إلى الوردة ويوازيها بالبحر، هذه المعاني التي رسمها ظهرت عن طريق دلالات توضيحية، فليست هناك بنية مختفية عبر تواصله النصّي.
عن طريق اللغة والتموضع الدلالي، سوف نبحر مع بعض العناوين التي تساعدنا على دراسة ما قدمه الشاعر الخزعلي من نصوص وأدوات نصّية أراد منها أن تكوّن عالماً خاصاً به:
الأثر اللغوي... الأنساق اللغوية وظهور الدلالة
متعلقات الوحدات الدلالية...
الأثر اللغوي:
يقول الشاعر والناقد الإنكليزي ت. س. إليوت: (إنّ الشاعر لا يملك " شخصية " ليعبّر عنها، ولكنّه يملك واسطة معينة و" يقصد اللغة "). فهناك اللغة على طبيعتها، وهي التي نتعامل بها بشكل يومي، ولكن هناك الأثر اللغوي، وهو الذي نسعى أن نكون تحت ظلّ تأثيراته وأنواعه المتواصلة، فاللغة الرمزية مثلاً، تعانق اللغة السريالية، بينما اللغة الوصفية تختلف عنهما، ومن بهذا الأداء، في التشكيل اللغوي للنصّ، نلاحظ أنّ للبناء اللغوي للنصّ الشعري أثره في التمكين والإمكانية النصّية، وينطلق من العلاقات السياقية والروابط النصّية، ونؤكد على أهم علاقة تظهر في النصّ هما دلالتا المعنى واللغة.
إنّ التحضير اللغوي، هو التحضير النصّي عندما تكون الذات الحقيقية قد استقرّت في أبعاد الأحلام المختلفة، وفي الوقت نفسه تجذب معها الجسر المهمّ في التخييل النصّي، حيث أن لغة الأحلام تؤدي إلى لغة الخيال والتي هي الأثر الفعّال في الخلق النصّي.
للتاريخ/ مهارة ٌ في تعطيل ِ الحاضر ...!
*
تاريخ ُالماء
تاريخ ُ الله ...
*
رأس ُ المال ِتاريخ ُ رأس ِ ماركس...
*
الذوبان ُ تاريخ ُ روح ِ الصوفي...
من قصيدة: مكاشفات في التاريخ – ص 16 – كتاب (النزهات).
إنّ المعطيات الإدراكية تستجيب للتصوّرات الخيالية، وتكون اللغة في هذه الحالة ذات تداخلات حيّة، استجابة لما تعلّق بالذات الحقيقة، ومن هنا يكون دور اللغة الخيالي هو المتعاطف مع المعطى الحسّي الداخلي؛ لذلك تتكوّن واجبات للغة ومنها إعادة التصوير الداخلي وظهوره عند الخلق النصّي، ولكن لن تتوقف اللغة هنا، بل تعمل على تصوّرات مستقبليّة وتتجانس مع الفعل الجديد.
للتاريخ ِ + مهارة ٌ في تعطيل ِ الحاضر ...!
تاريخ ُ + الماء ِ + تاريخ ُ الله ...
رأس ُ المال ِ + تاريخ ُ رأس ِ ماركس...
الذوبان ُ + تاريخ ُ روح ِ الصوفي...
اشتغالات في الذات الحقيقة وهي تأتي بقدرتها ما بين الواقع الآني والتذكّر الماضوي، ومن خلال هذين النوعين من الاستدراج الكتابي، نلاحظ أنّ الشاعر يميل إلى شبه الحكمة، متّـكئاً على أحداث حقيقـيّة، لكنّها معطيات تقودنا إلى التجدّد؛ فعندما يكون التاريخ مهارة في تعطيل الحاضر، فهذا يعني إنّ الخزعلي ومن خلال تجربة إدراكية يكون قد وضع الماضي (التاريخ) على الحاضر، فقد جعل المكان على الزمان والمكان، فالحاضر له مكانه الآني؛ وأما تاريخ الماء، فهو تاريخ الحياة.
وبهذه التقديرات الخيالية والتصوّرات فقد أرجع رأس المال إلى الذهنية التي اشتغلت عليه، أي أنّه جعل الأسس التواجدية نزعة للتبادل بين الحقيقة (المادة المنظورة) والصورة التي رافقت القول الشعري؛ ب هذه الدلائل نقيس الدلالة القصدية التي لجأ إليها الشاعر، بداية من خصخصة الموضوع وانتهاءً بالطبيعة المرنة العامّة.
السياق اللغوي وظهور الدلالة:
في السياق اللغوي وظهور الدلالة، هناك تظهر الدلالة اللغوية وكذلك دلالة المعنى، أمّا أثر السياق في توجيه النصّ، فهو أثر شموليّ، لا يقتصر على الكلمة أو الجملة أو العبارة، بل يشمل النصّ بأكمله، وإذا أشرنا إلى الوظيفة السياقية، فعندها نكون في المنطقة التداولية (ويأخذ مصطلح السياق مساراً أكثر بعداً مع الدراسات التداولية " " Pargmatique والتي عمّق أصحابها مسألة السياق اعتماداً على تجاوز الإطار اللغوي المحض إلى السياق الاجتماعي والنفسي والثقافي، حيث أنّ التداولية كما حدّدها "رودلف كارناب " هي قاعدة اللسانيات)(5).
لا تظهر الدلالة إلا عن طريق السياق اللغوي، وهي تتبع خصوصيّة تركيب الجملة من جهة، والمعاني الجديدة التي نحصل عليها من جهة أخرى. وإذا رجعنا إلى المعنى المعجمي (المرجعي) فسنلاحظ أن الفرق يعدّ كبيراً، ولكن في الوقت نفسه يسقط النص في حالة من التقريريّة وهذا ما تستبعده الشعرية، لأنه يخرج عن الثقل الشعري، ولا يعطي المساحة الكافية لتوليد سياقات جديدة متكئة على حركة التخييل النصّي والحركة الرمزيّة التي تصاحب النصّ والذي يكون ذا طراز جديد.
رفيف ُ الثوب ِمنه ُ العشب ُ ينخطف ُوهذي الريح ُ لم يهتز ْ لها السعف ُأُبادل ُ حيرتي صمتا ً وأغنية ً وفي الحالين ِ ملتفتا ً فلا أمشي ولا أقف ُ
من قصيدة: مكاشفة في التعارضات – ص 18 – كتاب (النزهات).
لا بدّ أن تكون دلالة المعنى جزءاً من نظام العلاقات اللغوية، بهذه العلاقات من الممكن توظيف المفردات الدالة، وقد يكون (حسب السياق) للمفردة أكثر من معنى أو أكثر من تأويل، حسب موقعها التركيبي، لذلك قد يكون للدال أكثر من مدلول؛ ومن خلال النصّ الشعري، يتعلق المعنى الدلالي إمّا بالإيحاء أو يختفي خلف رموز وإشارات تؤدي إلى الدلالة النصّية.
رفيف ُ + الثوب ِ + منه ُ العشب ُ ينخطف ُ + وهذي الريح ُ لم يهتز ْ لها السعف ُ + أُبادل ُ + حيرتي صمتا ً وأغنية ً + وفي الحالين ِ ملتفتا ً فلا أمشي ولا أقف ُ
يساعدنا المنطوق على الكتابة النصّية، وذلك التواجد التنغيمي أوّلا، ولفظة القافية ثانياً، وما ظهور الإيقاع إلا عامل مساعد يؤدّي إلى سهولة اللفظ والتأثر به، وهذا يعني أنّ فعل الإثارة له عدّة اتجاهات، وهو الفعل الدال الذي يختفي خلف النصّية وظهوره في السياق المكتوب.
لقد اعتمد الخزعلي على لغة الاختلاف والتي تولد لنا الدلالة الأصلية غير الواضحة، من الدلالة الأصلية نلاحظ ثمّة توضيحات دلاليّة تتعلق بالزمن اللغوي، وهي المعاني التي تكون بدلالة غير لفظية. لنأخذ الأفعال التي وظفها الشاعر، فهناك أربعة أفعال متفرّقة، ومنها شكّلت قافية، ينخطف، يهتزّ، أمشي وأقف... بعضها كان حركياً مثل الفعل ينخطف، وبعضها تموضعياً، وقد شكّلت هذه الأفعال؛ دلالة الحال، أي أنّ الأفعال أفعال آنية.
متعلقات الوحدات الدلالية:
في الذات الحقيقية هناك متعلقات دلاليّة بعضها مسموعة وبعضها مرئية، وتعد الوحدة الدلالية القاسم الرئيسي في توجيه وتعدّد المعاني، فتشكّل الجزء القولي للقول الشعري. (معظم الوحدات الدلاليّة تقع في مجاورة وحدات أخرى، وإنّ معاني هذه الوحدات لا يمكن وصفها أو تحديدها إلا بملاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لها)(6).
يكون امتداد المعاني عن طريق المجاورات الدلاليّة وذلك لأن النصّ الشعري يتوقف على أنساقه، فالمكتوب أمامنا هو الذي يظهر كخصائص بنائيّة تؤدي إلى التوازن النصّي، وتشكّل الخصائص ماهيّة النصّ في حالة خلقه. وعندما نكون أمام المفردات والتي تأتي بشكل لا شعوري ضمن المنظور الخيالي، نلاحظ أن الشطر الشعري لدى الشاعر يأخذ حالة التركيب المباشر، أي ليست هناك تخطيطات أو تفكير تفصيلي يدعم عمل الذات الشاعرة والتي تتحوّل بحكم تجربة الشاعر وكيفية الخوض في هذا المجال.
(5)
الزوال ُعادة ُ المرايا وأنت َ تُكثر ُ الوقوف َ في عمقها ...
(6)
المسافة ُحجرٌ بين َ نقطتين ِ في الزمان والأرض ُ مفتونة ٌ بهذه الكروية ...
(7)
الغيمة ُتاريخُها الماء ُ وهذي السماء ُ تشطبه ُ...
من قصيدة: مراجعات الصحو – ص 35 – كتاب (النزهات).
على الرغم من أنّ التراكيب اللغوية للكلمات تتكئ على التوحيد (التركيب الموحّد)، إلا أنّنا نلاحظ بأنّ الجمل المركبة في النصّ الشعري الحديث تعتمد الامتداد، أي يكون السابق مع اللاحق، ومن هنا يكون للمعنى امتداده أيضاً، وتعدّده ضمن الوحدة التركيبية، وبهذه العملية تظهر الوحدات الدلالية التي تعتمد المعاني من جهة، والدلالات اللغوية والتي تكون ضمن التأسيس النصّي من جهة أخرى.
الزوال ُ + عادة ُ المرايا + وأنت َ تُكثر ُ الوقوف َ في عمقها ...
المسافة ُ + حجر ٌ بين َ نقطتين ِ في الزمان + والأرض ُ مفتونة ٌ بهذه الكروية ...
الغيمة ُ + تاريخُها الماء ُ + وهذي السماء ُ تشطبه ُ...
وفي النصوص الثلاثة نتبين أن هناك دلالة توحيدية، وتختلف بالمعاني طبعاً؛ الزوال، المسافة والغيمة، جميعها كلمات دالة وتحمل معنى انفراديّاً، ولكن عند التركيب، تختلف معانيها، فتكون الجملة امتدادية، وفي الوقت نفسه نلاحظ؛ غياب الأفعال الحركية، ففي هذه الحالة تكون الوحدات الدلالية غير مرتبطة بالفعل الحركيّ، ونعد هذه المفردات أصغر وحدات لغوية تجانست مع النصوص، فمفردة زوال اشتقت من الفعل زال والذي يكون (مورفيماً)(7) مصغّراً من الممكن أن نشتق منه عدة كلمات تعتمد التركيب.
ونقيس بقية الكلمات بالاتجاه نفسه، حيث أنّ التعبير الحسّي الدلالي كان قد سيطر على اتجاهات النصّ، فظهور المعاني متعلقة بالوحدات الدلاليّة من جهةٍ، وبالإشارات من جهةٍ أخرى، فتكون العلاقة بين الرمزية والنص، علاقة وعي وديمومة، وبالاستدلال نكون في منطقة منتجة للمعاني وهي قصديّة الشاعر (الباث) عندما يكون متسللاً عبر الذات الحقيقية الدالة وعبر تعدد الدوال.
المصادر
-
يذهب الكثير من العلماء والمفكرين إلى اعتبار العلاقة بين الدال والمدلول علاقة تتحكم فيها الضرورة، وأنها علاقة تطابق بين الشيء وبين ما يدل عليه في العالم الخارجي انطلاقا من محاكاة الإنسان لأصوات الطبيعة، هذا ما أكد عليه أفلاطون (427-347ق.م) قديما في محاورة كراتيل (كراطليوس) عندما اعتبر ان العلاقة بين الكلمات ومعانيها هي علاقة مادية تحاكي فيه الكلمات أصواتا طبيعية، حيث يكفي سماع الكلمات لمعرفة دلالتها، كخرير المياه، نقيق الضفادع، زقزقة العصافير.... إلخ.
-
تفسير ما بعد الطبيعة، تحقيق: عبد موريس بوينج، المجلد الثالث، كتاب اللام، ص:16،14.
-
النقد والإبداع الأدبي، محمد العيد، دار الفكر للدراسات القاهرة، ط1 لسنة 1989. نقلا من كتاب: أدوات النصّ، دراسة، تأليف: محمد التحريشي، من مشورات اتحاد الكتاب العرب لسنة 2000م. دمشق، ص 61.
-
الاتجاه الأسلوبي البنيوي في نقد الشعر العربي، الدكتور عدنان حسين قاسم، ط1 لسنة 2001م، الدار العربية للنشر والتوزيع، ص169.
-
السياق والنصّ الشّعري، علي آيت أوشان، ط1 لسنة 2000م، دار الثقافة، مطبعة النجاح الجديدة.. الدار البيضاء، المغرب، ص 16.
-
علم الدلالة، الدكتور أحمد مختار، عالم الكتب، ط2 لسنة 1988م، ص 68 -69.
-
المورفيم: وقد سبق تعريفنا للمورفيم بأنه أصغر وحدة ذات معنى، وربما كان من الممكن كذلك، أن يوصف بأنه سلسلة من الفونيمات ذات المعنى التي لا يمكن تقسيمها بدون تضييع المعنى أو تغييره، إذا نحن أخذنا تتابعًا مثل posta نجد من الممكن تقسيمه إلى مورفيمين هما: s+post؛ "s هنا تؤدي معنى الجمعية الإضافي". نقلا عن: أسس علم اللغة، تأليف: ماريو باي – ترجمة: الدكتور أحمد مختار عمر، ط8 لسنة 1998م، عالم الكتب، القاهرة، ص 101.