
الشعري والتاريخي في (بريد الفتى السومري) للشاعر عدنان الفضلي
تشكل عتبات النصوص وجوداً جوهرياً ضمن مجموع النصوص التي يتكون فيها الكتاب الأدبي وتؤدي دوراً مركزياً لافتاً للانتباه وأحياناً كثيرة تتجاوزها قراءات المتلقي، على الرغم من كونها تمثل وسيطاً ضرورياً بين المتلقي والنصوص، وهي قادرة على فتح مجال إبداعي، يضيء النصوص أو بعضٍ منها، كما أنها تضيء كونها تكوينا ثقافيا وبنائيا في العمل الأدبي، بالإضافة للذي تتمتع به من مشاركة بنائية، ليست خارجية، أو هامشية، بل هي ذات حضورٍ بنائي داخلي وفي أحيانٍ عديدة يتحول إلى موجود عميق تنشغل به القراءات النقدية.
هذا رأي وأنا أدخل لقراءة المجموعة الشعرية “بريد الفتى السومري” للشاعر عدنان الفضلي، وأول ما يلفت انتباه المتلقي، العتبة الأولى وبدون عنوان، لأنها تكتفي بما انطوت عليه من إشارات ذات بلاغة قوية، لأنها مكتوبة عن سومر، التي لا تحتاج عنونة لهاـ لأنها مكتفية بكنيتها التي تجاوزت جغرافيتها لتمتد نحو جغرافيا عالمية.
لقد قصدت بمنحي “الجغرافيا” لسومر ولا تحتاج إلى إيضاح إلى المدينة السومرية العتيقة “الناصرية” التي علمتني ما لم أعلم. وإلى الشرفاء الذين أنجبتهم وفي مقدمتهم (عقيل الناصري، سهيل عبد الله، وأحمد علوان فارة).
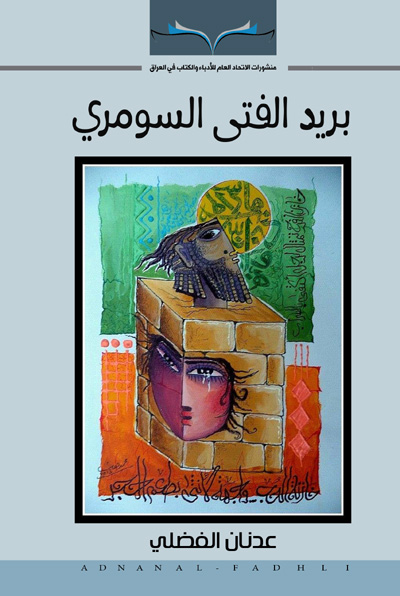
الإهداء مثير، لأنه حاز هذه الصيغة في تنوعه الطافر عن النمط والتقليد واختار الشاعر الفضلي ثلاثة أسماء رموزاً تنتمي إلى سومر.
ملاحظتي الأولى “الناصرية” التي عدّها الشاعر عتيقة، بينما هي جديدة باستمرار، متجددة في كل يوم، لأنها منذ زمنها الأول صارت منبعاً لتغذية المدن العراقية بما لم يكن فيها على الرغم من التماثل بين الناصرية “سومر” وبين المدن الأخرى بما عرف عنها حضارية، لكني أعني الدور الثقافي والسياسي الذي اختارته هذه المدينة وانفردت به، وتحولت إلى منبر للجميع “الكلمة”، القول بأن الأسطورة تتسلل في السرد والشعر، ليس متطابقاً مع التاريخية الخاصة بالفنون/ الآداب. لأن الأسطورة، النوع الأول في تاريخ الحضارات الأولى، وخصوصاً الشعرية. وعلينا أن نؤشر بأن اقتناص الأسطورة، يعني العودة إلى الشعر، من أجل قيادته إلى الحاضنة الأولى، واعتقد بأنه لا يمكن المداخلة أو التشارك بين الشعر والأسطورة، لأنهما معاً تكونا في لحظة، قد تبدو واحدة، لكنهما يساكنان فاصلة بينهما - وهذه عتبة جوهرية وضرورية، لأنها تؤكد وجود العتبة الأسطورية أولاً ومن بعدها ما هو ملاحق للأسطورة من طقوسٍ وعقائد وشعائر، لكن الشعر هو التالي.
هذا ما نريد الوصول إليه والتعامل وإياه، بوصفه ركناً مكرساً لا تستطيع العلاقة الأدبية والثقافية، فك الاشتباك بينهما. واستطيع الإشارة لذلك من خلال شاهد ولكنه جوهري وضروري، إنه نص للشاعر عدنان الفضلي (الناصرية التي في العلى). وهذه العنونة مثيرة للحيرة والدهشة لأن التاريخ حقيقي. الشعر كامن وحاضر وسط التاريخ. وتاريخ قصيدة الفضلي، محيرة، مثيرة للقلق والإثارة، والسبب في حصول ذلك، هو المتن النصّي وما يثيره من أسئلة وإشكالات، ليست شكلية، تبرز أحياناً في بعض القصائد التي تذهب سريعة، من أجل توضيح الأسطورة/ الطقس/ الشعائر/ السحرية. التي هي أعقد السحريات والأسطوريات لأنها تستلزم الخضوع لعلاقات السلطة والاشتباك معها، وعدم الاستسلام لإخضاعاتها، وإنما الإعلان عن بقاء القوة المترامية بفضاء ليس ضيقاً، بل هو متسع وعميق، لكن الإشكالية هي، هل بالإمكان التجاور مع الأسطورة/ الحكاية/ مقدس/ واضح؟، وليس ملتبسا. أنا أنبه لذلك من أجل خلق صدمة ثقافية قوية وعارفة. حتى تفضي لمساحة مضادة، متشاكلة، لأن الحضور، متوتر، مشكوك به.
وكثيراً ما تحدثت مع أصدقائي أبناء هذه المدينة مع أنني عندما كنت قادراً على زيارتها باستمرار بدعواتٍ ثقافية، ولحظة أغادرها، أجد نفسي أستدير إليها، ملتفتاً لما تركت ورائي، للعلاقة العميقة التي تربطني منذ زمنٍ مبكر جداً، لا للسبب الحضاري وإنما السياسي أولاً وهو الذي قادني لاحقاً لما أنا فيه منذ سنواتٍ طويلة.
هذه هي المدينة الجديدة، التي تنزع جلدها سنوياً وتعلن عن انبعاثها وتجددها من أجل الحفاظ على ديمومتها.
1 - الناصرية التي في العلا
اختار الشاعر الفضلي عنونة مهمة جداً للعتبة ذات الشعرية، لكنه لم يرد التورط بازدواجٍ ثنائي بين الناصرية وبابل، على الرغم من أن الناصرية هي الأصل الذي أفضى إلى “حينما كنا في العلا” وإضفاء مثل هذا تاريخي متواصل، وأساطير مع عقائدها وطقوسها وسحرياتها، وأيضاً مع كل الأنظمة التي صاغتها سومر وانتقلت بهدوءٍ متحاور مع الأصول إلى أكد، وحازت بابل ما شاء لها أن تختار، واعتقد بأن عنونة الفضلي “الناصرية التي في العلا” ليست بعيدة عن المكان لأنه منح هذه المدينة بعضاً من الذي أنا تحدثت عنه وركزت عليه بوعي تام.
فالناصرية التي في العلا، منذ لحظتها الأولى وحتى الآن. وتضمن هذا النص التماعات ذات طاقة شعرية، تقود المتلقي بهدوءٍ ومرونة، ليتعرف على بعضٍ من تاريخ هذه المدينة، وحتماً لا يقوى الشعر على تدوين التاريخ إلا عن طريق صفته الملحمية. لذا اختار الفضلي السرد لاقتناص التاريخ أو لاحتضانه، لأنه موجود وغير بعيد. واللغة الشعرية دائماً ما تتمكن من مطاردة التاريخ وتتلاعب بوقائعه وأحداثه وتقدمه للمتلقي نصاً مدهشاً ومثيراً بتنوعات الوحدات السردية فيه.
أنا واثق بأن نص “الناصرية التي في العلا” عتبة مكان كان وما زال منعكساً على سطوح المرايا والمدهش أن هذه المرايا ليست محددة بمكانٍ هو الذي ذهب إليه الشاعر الفضلي، بل المكان هو الجغرافيا الواسعة، والمتشظية.
واجهت هذه المرايا كثيراً من الرضات وصارت كسراً موزعة في ما لا يحصى من الأماكن هنا في جغرافيات العالم. ضغط الفضلي على الذاكرة الفردية والجمعية للأفراد، وضغط على جرس الخزان، كي يستعيد ما كان سرداً في حقبٍ من تاريخٍ طويل. لذا استطاع الشاعر اصطياد نجاح مهم، تمثل في إخضاع المتلقي لشعرية سرده التاريخي لبعض الشواهد والمشاهد وكأنه يدعونا بهدوء بلغته أن نعيشها مرة أخرى، أو يأخذ من لم يعشها من أجل التعايش معها من جديد.
“في الطريق إلى الناصرية..
قد يصادفك مشحوف، لم يكتب عليه لفظ الجلالة.
إنه يعود لبوذا، وقت جاء يتعلم العزف الجنوبي،
في مضارب بني أسد
نسيه عن جدتي التي أورثتني الضلالة السومرية اللذيذة..
قد تسقط نظراتك على أطلال بئرٍ، تحرسه أفعى خضراء،
هذا منبع الأهوار، التي سكنها شعب يتلو على نفسه فقط،
الأبوذيات التي تكتبها النسوة، مدافة بالطين وبقايا القصب (ص7)
اخترت هذا النص اعتباطاً، وربما بسبب موقعه ضمن النص استهواني جداً، لأنه اختصر كثيراً من أساطير وعقائد وطقوس. وأشار بذكاء للدور الأمومي الذي اضطلعت به الآلهة الأم الكبرى وظلت بحضورها حتى هذه اللحظة، عبر كل ما تركته من نظامها الثقافي والديني. كما وجدت وهذا ما سأحاول المرور عليه سريعاً.
اعتباطية الفضلي في التقاط تجوهرات ذات صلة عميقة مع عتبات سومر الأولى. هذا يعني استمرار موروثها المودع في ذاكرةٍ قوية ويقظة وسنرى تأثيرها في الوعي واللاوعي واستيقظ بلحظةٍ ما وجدت حاجة حياتية لتلك اليقظة، لكن عارض مجتمعي، جمعي، أو فردي هو الذي أزاح المتراكم فوق الثابت الذي لا يغيب تماماً، بل يختار لحظة يقظته. كما أن السرد يستقوي على ما تتوفر فيه من عناصر، لها صلة بالتاريخ. مكونات، أو عناصر نظام الإلوهة المؤنثة بشغاقة، لأنها استعانت بالذاكرة والشعر. فالمشحوف رمز بكري، موجود، لكنه غادر علاقته بالرب، مثلما كانت تتعامل معه سومر. والأساطير التي كان المشحوف مجالاً حيوياً فيها، عديدة، ومثال ذلك، هروب الآلهة (إنانا/ عشتار) معتمدة عليه عند سرقتها للنواميس الإلهية من “أنكي” وهربت بها إلى مدينة أوروك. فالمشحوف في نص الفضلي لم يكن إشارة عابرة لوجوده في التداول اليومي الآن، بل هو جزء مكتظ بأساطير خاصة بالديانة السومرية وامتد وعرفته أسفار التوراة كوظائف الانتقال والحركة للإله (يهوه)، متماثلاً بما كان يفعله آلهة سومر.

عدنان الفضلي
وأضاف الشاعر معلومة خاصة ببوذا واقترانه بالمشحوف ولذلك رواسب موجودة في بعض المرويات عن وجود أقوام وفدت من الهند إلى سومر، واختار الفضلي للتنوع المقدس أن يكون بوذا موجوداً، أنه يوظف الشعر من أجل طاقة الرمز الكامن، والذي يفضي للدلالة، لأن الديانة البوذية متأخرة كثيراً للغاية عن ديانة سومر. فالقرن السادس ق. م هو اللحظة التاريخية الحضارية التي تحدث عنها جورج سورتان في عمله الموسوعي “تاريخ العلم”. وأشار إلى أن تلك اللحظة هي أهم ما عرفه التاريخ في الشرق وتجاوز المانونية/ الزرادشتية/ المسيحية/ البوذية/ هل أراد الفضلي الإشارة للتشاكل الثقافي والديني والعلمي عبر الإشارة لبوذا؟
ملاحظة الفضلي بشأن العزف ورغبة بوذا بتعلمه من سومر مباشرة وعبر العلاقة الدقيقة مع روحها لها شيء من الصواب لأن الموسيقى في سومر أقدم من الهند بكثير. واعتمدت الموسيقى في الهند حتى هذه اللحظة، معياراً للتعامل مع الكائن لحظة تعلمه الموسيقى ويحوز بذلك كينونته وآدميته. أنا أتحدث عن نص فتح لي منفذاً للحديث ولا يعنيني الفضلي، عرف ذلك أم لم يعرف! المهم ما فجره النص من تداعيات ثقافية في داخلي وأنا اسجل ملاحظاتي عن عتبتي الديوان فقط، ويبدو لي واضحاً أن الشاعر الفضلي يأخذ المتلقي نحو الرضا والقبول بالمعلومات الافتراضية ويقنعه بها. مثال ما ذكره عن مجيء بوذا وتعلمه العزف الجنوبي في مضارب بني أسد. وهذه الإشارة تحويل الافتراض إلى واقعة معلومة ومعروفة في التداول وصارت ذات حضور قوي عبر التواتر. أما رمز البئر وعلاقته بالأفعى الخضراء فهو ظاهراتياً متنوع الدلالة، ولعل أهمها هو التعامل معه بوصفه فرجاً، ولم يكن هذا الحضور الرمزي غريباً، لاسيما وأن سومر عرفت طقوس الزواج والجنس.
وهو لا يبتعد تماماً عن معناه الجنسي والبئر أثر الموجودات وجوداً قوياً وعرفته المراحل الحضارية العراقية منذ سومر وحتى آشور. ولم تكن ملحمة كلكامش بعيدة عن هيمنة هذا الرمز وتكرره ست مرات ووظفته حقبة التوراة ووظفوه كثيراً والتأثير واضح للتماثل بعدد التكرارات. واعتقد أن الحضور البئري والنبعي والعيني يمتد كثيراً في كل ديانات الشرق ودارت حولها الكثير من الأساطير والعقائد والبئر في سبيل المثال - هو الشاهد على ضياع عشبة الخلود التي عاد بها الملك جلجامش وسرقتها الأفعى بعد نزوله للبئر للاغتسال أو التطهر. وتعاود الأفعى حضورها مرةً جديدة، لكنها في هذا النص ذات لونٍ أخضر، دلالة لاقترانها بالانبعاث ولونه الدال على الحياة. كما اعتقد بأن مجاورة الأفعى للبئر، كافية لتأكيد المعنى الذي ذهبت إليه بشأن الجنس المقدس.
منح الشاعر البئر كنية أخرى، أنه نبع، وهذا ممكن لأنه يتمتع بحضورٍ قوي. ومن البئر تصاعدت وامتدت مياه الأهوار وتسيدت بقوةٍ هائلة شخصية الإله “إنكي/ آيا/ الإله الخاص بالآبسو وهو منتج كل ما له حضور في كل الأهوار.
من هنا أنا اعتقد - مثلما أشارت الدراسات - إلى أن هذا الإله أكثر الآلهة في مجلسهم بالعراق القديم عقلاً وحكمة وخبرة في مناصرته المستمرة للمضطهدين من الأفراد والجماعات ولا حاجة للتذكير بذلك لأنها كثيرة.
الأهوار سكنها شعب يغني لنفسه فقط نصوص الأذى والضيم والجوع التي ابتكرتها النسوة امتداداً لوظيفةٍ مبكرة اقترنت بالآلهة الأم الكبرى، الأم السومرية: ننخرساك/ ماما/ مامي هي التي أسست نظامها الأمومي ووظائفها الحياتية، الرقص/ الشعر/ الغناء/ العطور.
قال الفضلي ما نعرفه عن الأصول المبكرة التي كانت الأم السومرية هي المنتجة والمرسلة لها لكل حضارات الشرق.
ليس هذا فقط، بل وظف الفضلي عناصر الشعر المستعارة من الأسطورة التي هي الأصل الأول، كما قال “الأبوذيات التي تكتبها النسوة، مدافة بالطين وبقايا القصب”. المخيال أخذ الفضلي نحو عتبة الخلق الأولى والتكوين المبكر حيث الطين، عنصر الخلق السومري والأكدي، فالارتكان للغناء من الأبوذيات تعني خلقاً، لأن الطين العنصر الأول في إبداعات الأم الأولى، ليس من الطين فقط، بل من القصب.
هما المركز الحيوي القوي، والجبار للحضارة السومرية التي امتدت وصعدت للشرق وما زالت حتى هذه اللحظة تغذي الناصرية التي بالعلا بمخزونها العظيم وموروثاتها.
2 - في الطريق إلى الناصرية
ستلاحظ ثمة مسرى على شكل زقورة
تنتصب في ساحةٍ عتيقة،
هذا طريق الله الذي تسلكه الملائكة
فالرب في صومعته العليا...
وكلما نال منه العطش،
بعث بطلب شربةٍ من الفرات،
وكلما جاسه الحنين إلى خلقه الأولين..
أرسل بمن يأتي له بمطربٍ سومري عتيق... (ص9 )
في المقطع الثاني لنص “في الطريق إلى الناصرية” حصل تراكم واضح بما يجعل من الناصرية مكاناً غنياً بمتروكات هي علامات واضحة على التاريخ، والعلامات عيانية/ شواهد، آثار، وليست سرديات مثلما في البداية. وهذا المقطع المغتني بما عرفته سومر. وهو أبرز معالم لحظة سومر العظيمة، وهي زقورة أور. واللافت للانتباه التتالي في الكشوف حتى تكتمل الصورة التي جعلت من الناصرية في العلا والزقورة التي تضمنها المقطع الثاني هي زقورة الإله ننا/ سين والتي رممها طه باقر وفؤاد سفر، وهي قائمة وسط ساحة واسعة جداً وعلى يسارها مقبرة الملوك.
إشارة الفضلي لزقورة ننا/ سين تعني حضور سومر في الذاكرة، فلا وجود لسومر بمعزل عن الزقورة وهذا هو السبب – كما اعتقد- الذي جعل طه باقر وفؤاد سفر يقومان بترميمها بالكامل وحتى المكان الخاص بالإله هابطاً إليه من السماء.... إنه في قمة معبده ودائماً ما يرتشف ماًء فراتياً، عندما يشعر بالعطش، هو الذي يطلبه. هذا الإله المتعالي المندهش بحنين مفاجئ لأول من خلق. وهذه ملاحظة مثيرة، لأن الإله نانا/ سين كان إلهاً خالقاً مثل الآلهة: آنليل، شمشي، آنكي. وإشارة الخلق حضور الشعر من أجل كسر السياق الرتيب وتحطيم النمط بالإضافة المجددة لما هو جديد، والخلق الأولين، فضلاً عن المخيال الشعري للسياق الذي حطم الانتظام النثري.
يفتتح الشاعر عدنان الفضلي فجوة صغيرة جداً، تجعل من الإله نانا/ سين متصلاً عن طريق الطاقة الشعرية في خاتمة النص وهو يحلم بمطربٍ سومري عتيق، يريد الاستماع له مرتلاً الأغاني التي كتبتها النسوة ممزوجة بالطين والقصب.
هنا توحيد للمقطعين في نص “الناصرية التي في العلا” والتي سمحت لإلهٍ حضر في تخيلات الشعر إلى الحاضر وهو يستمع إلى داخل حسن