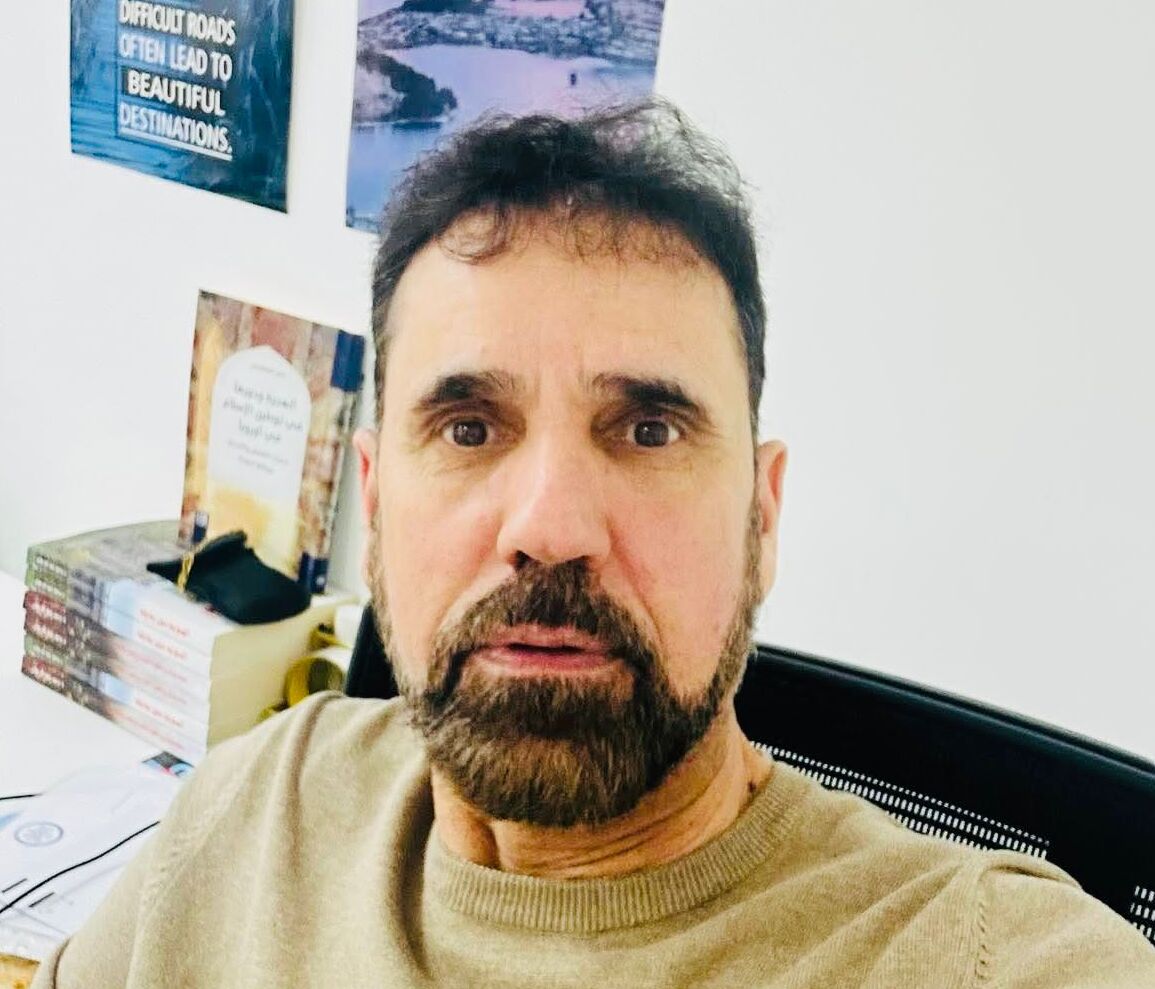
ملخص
يتناولُ هذا المقالُ المقتضبُ المُفكرَ العراقي المختص بعلم الاجتماع الأستاذ عبدالفتاح إبراهيم (1904 - 2003)، الذي يُعد من أبرز المفكرين والمثقفين العراقيين في القرن العشرين، ومن رواد الحركة الاشتراكية والنقابية في العراق. جمع بين التنظير الفكري والممارسة السياسية والنضال النقابي. فضلا عن ذلك، فهو أول أكاديمي عراقي تخصص بعلم الاجتماع. وهو صاحب أول المؤلفات العلمية بهذا التخصص التي صدرت بصيغة كتب تقدم علم الاجتماع للقراء قبل أن تكون هناك مؤسسة أكاديمية تدرسه، بعد إلغاء جامعة آل البيت ببغداد(1)* كذلك يسلطُ المقالُ الضوءَ على مساهماته الفكرية الأخرى، ودوره التنويري الريادي في العراق، إضافة إلى توجهاته الفكرية.
أولاً: مقدمة تعريفية
يُعتبر الأستاذ عبد الفتاح ابراهيم الرائد الأول لعلم الاجتماع في العراق كما ذكرنا، وذلك وفق معياري دراسة التخصص والتأليف فيه (2) فهو من مواليد عام 1904 في مدينة الناصرية، وينتسب إلى عائلة من مدينة حديثة بمحافظة الأنبار غرب العراق، حيث كان والده يشغل وظيفة واعظ غرب الفرات. تتلمذ عبد الفتاح إبراهيم في البصرة وأتم دراسته الابتدائية هناك. ثم أكمل دراسته الثانوية في بغداد سنة 1920 – 1924، بعدها سافر إلى بيروت في عام 1924 للدراسة في الجامعة الأمريكية (3).
بعد إكمال دراسته في بيروت عاد إلى بغداد ليعمل في حقل التعليم، لكنه لم يستمر في ذلك إذ سافر إلى أمريكا عام 1930 لإكمال دراسته العليا في جامعة كولومبيا، حيث أنجز كتابه (على طريق الهند).
ثانياً: المساهمات الفكرية
يُعد المفكر عبدالفتاح إبراهيم رائدَ الفكرِ الاجتماعي، والتأليف في مجال علم الاجتماع في العراق كما أسلفنا. فوفق ما توفر لدينا، يكون هو أول من ألّفَ كتاباً في صُلب علم الاجتماع. حيث يُعتبر كتابه (مقدمة في الاجتماع) (4) أول كتاب مختص بعلم الإجتماع تم تأليفه من قبل مؤلف عراقي. ولعل هذا الأمر يجهله العديد من المتخصصين بعلم الاجتماع بمن فيهم العراقيون للأسف. كذلك لاحظنا جهلا كبيرا بهذا الكتاب وكتب ابراهيم الأخرى. ومن دواعي سرورنا أن نكون أول من نبه إليه، حيث عثرنا أونلاين بالصدفة على نسخة منه موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية (5).
لم يتضح تخصص علم الاجتماع في العراق إلّا مع مطلع النصف الثاني من القرن العشرين(6) حيث أفتتح قسم علم الاجتماع في كلية الآداب(7) بجامعة بغداد في السنة الدراسية 1951-1952، رغم أن هناك دراسات عن التخصص (علم الاجتماع) ظهرت قبل ذلك التاريخ بما فيها كتابات الدكتور عبد الفتاح إبراهيم(8).
وقد قام المؤرشف والباحث شهاب احمد الحميد (9) بجمع تراث المفكر عبد الفتاح ابراهيم ونشر بطبعات شعبية كلفته الكثير من ماله الخاص وهو جهد كبير يربو على ثلاثة وثلاثين كتاباً منها: على طريق الهند، الجذور الفكرية للحركة الديمقراطية في العراق (تأليف مشترك مع كل من محمد حديد وعلي حيدر سليمان)، الشعبية الديمقراطية ودولة القانون، مقدمة في الاجتماع، حرية الرأي والفكر، حقيقة الفاشية، منابع الفكر الديمقراطي بين النظرية والتطبيق، دراسات في الاجتماع، معنى الثورة، اهمية فلسطين، الاجتماع والماركسية، قصة النفط العراقي، السفسطائية اليونانية، نطاق التاريخ والفلسفة، كلمة في الحرب، الحرب والتطور الاجتماعي. يضاف إلى ما ذكر أيضاً كتيب (تعليق على مذكرة مستقبل التربية والتعليم في العراق)، كلمة في المنهج القومي، ومشكلة التموين، وكلمة في وجهة المجتمع بعد الحرب. كما ترجم كتاب (التربية والتعليم في الاتحاد السوفيتي العام 1932) و(مذكرات المهاتما غاندي) عام 1933.
في الكتيب الموسوم (تعليق على مذكرة مستقبل التربية والتعليم في العراق) والذي صدر عن مكتبة بغداد، 1944، ويقع بخمس وأربعين صفحة، يقدم الاستاذ عبدالفتاح ابراهيم مراجعةً وتقييماً، ونقداً لاذعاً للمذكرة التي أصدرها الدكتور محمد فاضل الجمالي وزير المعارف وقتها، ورئيس وزراء لاحق خلال فترات من العهد الملكي. ففي ذلك الكتيب كان رأي ابراهيم: "أن بحث الجمالي عن مستقبل التربية والتعليم في العراق كان عقيماً من وجوه كثيرة. لأنه أهمل معالجة المشاكل الأساسية كوحدة متلازمة اجتماعياً، وانصرف إلى ذكر التفاصيل التافهة التي يمكن أن يبت فيها على وجه من الوجوه في كل حين" (10) ورأى ابراهيم أن البحث في خطط المستقبل تقتضي النظر في امكانية تحقيقها وليس من باب التنبؤ. ورأى أن الدكتور الجمالي كان (مثالياً) وبالتالي فإن ابراهيم نقد المثالية والمثاليين في منهجية عملهم البعيدة عن الواقع. ورأى "أن حشره في زمرة المثاليين قد يغيضه ويغيضهم، ويغمط حق كثير من المفكرين الذين كان لهم شأن في تاريخ الفكر الإنساني" (11).
ونظراً للقيمة العلمية والريادية لكتاب (على طريق الهند)، نقوم بتقديم عرض لمحتوياته وتعريف موجز به. فالكتاب كان قد صدر أول مرة عام 1932، بحدود مئة وخمسين صفحة عن دار الأهالي. ثم قام المؤلف باصدار طبعة منقحة ومزيدة بلغت الضعف (351 صفحة)، عن نفس الدار. حسب تقديرنا فإن كتاب (على طريق الهند)، قدم فيه عبدالفتاح ابراهيم قراءة حلول الدور الاستعماري في إعادة تشكيل الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية. والكتاب يركز على منطقة الشرق الأوسط أكثر مما يركز على الهند. فالمؤلف قصد به مسير الاستعمار نحو الهند مروراً بالشرق الأوسط والأدنى. وبالتالي فهو من الكتب القيّمة الرائدة التي تؤرخ لمنطقة الخليج والهلال الخصيب تحديداً، ودور الصراع بين القوى الاستعمارية في تشكيل الكيانات السياسية وترسيخ النفوذ فيها.
تضمن الكتاب أثني عشر فصلاً موزعة على أربعة أبواب. ابتدأ الفصل الأول بنظرة على الخليج الفارسي(12) بسواحله العربية والفارسية، ثم فذلكة في تاريخ الخليج سلط فيه الضوء على (هرمز، مسقط، البحرين، السواحل المهادنة (13)، القطر (وردت هكذا)، الاحساء، المحمرة، الكويت، الفاو). وعَنونَ الفصل الثاني بـ (المصالح التجارية تتقدم المطامع السياسية)، وضمنه: اكتشاف طريق الهند: تجارة أوربا مع الشرق، طريق التجارة البحرية، المدن التجارية الايطالية والجرمنية(14)، سيطرة البرتغال على تجارة الشرق. بدء صلات الإنكليز بالشرق: تشبث الانكليز بالطرق الشمالية وطريق الفرات، فاتحة سيطرتهم على طريق رأس الرجاء الصالح، الصراع بين الانكليز والبرتغاليين والهولنديين في سبيل السيطرة على الخليج. والمنافسة التجارية بين انكلترا وفرنسا. وأول اتصال الانكليز بالعراق. وصلات بريطانيا بسواحل الخليج العربية.
أما الفصل الثالث فقد ألقى الضوء على سيطرة بريطانيا على الخليج في سبيل الهند، مبرزاً أهمية الهند بالنسبة لإنكلترا اقتصادياً وعسكرياً. حيث ينوه بأرباح شركة الهند الشرقية، وكيف استنزف التجار والرأسماليون الانكليز ثروة الهند، وأدوار الرأسمالية الانكليزية، وأثرها على العامل والفلاح الهندي فيما سماه (الاستعباد). كذلك يعرج في هذا الفصل على الاطراف المتنافسة على الهند بشخوص بعض أباطرة التاريخ الحديث مثل القيصر الأكبر، ونابوليون وصلاته بأمير مسقط وغير ذلك مما ساهم بترتيب الأحداث على المنطقة. في حين اختص الفصل الرابع بوادي الفرات باعتباره (أقصر الطرق إلى الهند) حسب وصفه، باعتباره منافساً لقناة السويس.
وفي الباب الثاني، خصص الفصل الخامس للرأسمالية الجرمانية (الألمانية) التي دفعت بألمانيا إلى النشاط الاستعماري حسب وصف المؤلف. وبحث الفصل السادس في مشروع سكة حديد بغداد (المقصود به سكة حديد بغداد - برلين)، حيث تناول أهميته السياسية، ومنافسة الشركات عليه، وتفضيل السلطان عبدالحميد الثاني للشركات الألمانية على غيرها. في حين أن الفصل السابع جاء مكملاً لموضوع مشروع سكة الحديد المشار إليه أعلاه، وتناول فيه تضارب مصالح الرأسماليين الأوربيين، وأثر الانقلاب العثماني عليه وغيره من المباحث.
في الباب الثالث، تناول الكاتب العوامل الاخرى التي تؤيد المصالح السياسية البريطانية في العراق، من قبيل: القطن والحبوب، والنفط، مسلطاً الضوء على ظروف اكتشاف النفط في العراق والصراع بين أصحاب المصالح الخارجية الدولية عليه.
فيما تناول الباب الرابع حالة الاستعمار البريطاني الدفاعية المتعلقة بالمشرق. حيث خصص الفصل العاشر فيه إلى بوادر اليقظة في الشرق الأوسط والأدنى، مركزاً على نهضة تركيا، والعهد الجديد في إيران، وبوادر النهضة في الهند، والحركة الوطنية في مصر. اما الفصل الحادي عشر فقد ركز على صلات روسيا السوفيتية بالشرق الأوسط والأدنى، وذلك من خلال تأثير الثورة الروسية في الشرق، وتعاونها مع بعض أطرافه. في حين أن الفصل الثاني عشر قد ركز على العراق باعتباره مقراً لمقاومة بريطانيا في الشرق الأوسط والأدنى. وقد بحث فيه: النزاع الاستعماري في الشرق الأدنى، والوحدة الإسلامية والدعوة العنصرية، والدعوة العنصرية في سوريا. ومبحث حول (إنكلترا في بلاد العرب)، وفيه: انكلترا وإبن السعود، والانكليز يستعينون بأمراء العرب ضد الوحدة الإسلامية، والسر خزعل(15) والسيد طالب باشا(16) والقضية العربية في العراق، وشريف مكة والقضية العربية، واشتداد الصراع بين الوحدة الاسلامية والوحدة العربية قبل الحرب العامة(17)، ومساعي الانكليز في نجد والخليج والحجاز، وفكرة مؤتمر الأمراء، والانكليز يستخدمون دعاة القضية العربية، وأغراض الحملة الانكليزية على العراق، والسير بيرسي كوكس ومساعيه، والحرب العامة وأثرها بصلات بريطانيا بالعرب، وغير ذلك من المباحث ذات الصلة.
تجد في الكتاب العرض التاريخي والرؤية السياسية، والقراءة الحصيفة لمجريات الأحداث خلال الحقبة التي سبقت تفكيك الدولة العثمانية ونشوء الكيانات السياسية الحديثة في الشرق الأوسط.
وتبرز تلك المؤلفات الدور التنويري والتعريفي سواء ما يتعلق بتخصص علم الاجتماع، أو مساعي الكفاح من أجل حرية الشعوب، سيما ما يخص العراق، بضمن ذلك اهتماماته بقضايا التعليم والمرأة والديموقراطية وغيرها.
ثالثاً: التوجهات الفكرية
من أجل القاء الضوء على التوجهات والتحولات الفكرية للمفكر عبدالفتاح ابراهيم، نورد ما أجاب به ابراهيم نفسه، حيث قال: "حصلت نقطة التحول عندي نحو الاشتراكية والاتحاد السوفيتي، خلال إعدادي لأحد البحوث الدراسية حول ثورة 1917 حيث لم يسبق اختياري لهذا الموضوع أية فكرة أو دافع للدراسة والبحث.. أما اهتمامي بالاشتراكية لأول مرة فمن خلال دراستي لكتاب هياس (Heyas)"(18). وهذا كان أول كتاب قرأه هناك في الولايات المتحدة الامريكية لهذا الكاتب الأمريكي الليبرالي، وهو بعنوان (تاريخ أوربا الاجتماعي والسياسي)، وكان حينذاك أول مرة يسمع فيها عن الاشتراكية التي أصبحت إحدى اللبنات الأساسية في تشكيل تفكيره.
فهذا الكتاب تناول الحركات السياسية والاجتماعية في أوروبا ومن ضمنها الحركة الإشتراكية بالإضافة إلى الثورة الفرنسية وما رافقها من مفاهيم حول اندحار الاقطاع وانتصار الطبقة الوسطى والديمقراطية والدستور (اني تعرفت على الاشتراكية بشكل اكاديمي مدرسي) (19).
ويرى الدكتور علي مرهج أن عبد الفتاح ابراهيم "آمن بتقدم الغرب وبضرورة تبني كثير من مقولاته مع ضرورة تبيئتها بما يتلاءم مع الواقع التاريخي والاجتماعي لمجتمعنا. فلم يكن يرفض التراث برمته بل يجده خزيناً معرفياً يمكن الإفادة منه في الحاضر وبناء المستقبل، لكن يجب قراءة هذا التراث قراءة نقدية وليست قراءة تبجيلية تقديسية، فضلاً عن ذلك فإنه لا يتبنى كل ما جاء من الغرب بل يرى ضرورة قراءة هذا الفكر الذي سبقنا أصحابه في التقدم لمعالجة كثير من القضايا المشابهة لمسيرتنا ومعاناتنا الثقافية. فليس من المعقول ان نبدأ من الصفر كما ليس من المعقول أن ننغلق على تاريخنا وماضينا، فالحياة في تقدم وتغيّر مستمر، لذلك نجد مفكرنا ينفتح على المختلف مستفيداً بطبيعة الحال من التجارب العربية التي ذكرناها سابقاً، فضلاً عن إفادته من مُلاحظة الواقع العربي بشكل عام والعراقي بشكل خاص".(20)
يمكننا القول أن مصادر الدرس الاجتماعي والفكري متعددة لديه ومتنوعة بين المدارس الاجتماعية
والفلسفية وخاصة الفلسفة السياسية فالفكر الماركسي مثلاً واضح عليه، ويُعتبر مصدراً ملهماً له فتوجهاته واضحة فيه، ولكنها اختلطت بالسياسة، واصطدمت بالواقع الاجتماعي الذي يحتاج إلى الكثير من الاشتغال. كما أن للمدرسة الداروينية تأثيرا يمكن أن يُلمح في بعض كتاباته عبر إيمانه باستمرار مسيرة الإنسانية باتجاه خطي نوعي يثبت الأصلح فيه أنه أهل للبقاء وغير ذلك(21).
باعتقادي أنه كان منقسم بين الماركسية والليبرالية، إن استطعنا تجزئة المفهوم. ولعل مبعث التجزئة يتأتى من المرحلة التي عاشها، ومصادر فكره ومرجعيته المشتتة بين الاشتراكية والليبرالية. وأنه حاول التوفيق بينهما، وكان على يقين من أن ظروف العراق الاجتماعية والاقتصادية تقتضي هذا الموقف الوسطي أو ربما الانتقالي في فهمه ومنهج عمله. فمن غير المعقول أن يكون لديه لبس في استيعاب المفهوم وتمثله، وهو الذي برع في الترجمة والتأليف وخلف لنا هذه المآثر التي نناقشها اليوم.
رابعاً: الدور التنويري
تُبرز المؤلفات التي كتبها المفكر عبدالفتاح ابراهيم، الدور التنويري والتعريفي سواء ما يتعلق بتخصص علم الاجتماع، أو مساعي الكفاح من أجل حرية الشعوب، سيما ما يخص العراق، بضمن ذلك اهتماماته بقضايا التعليم والمرأة والديموقراطية وغيرها. وتتمثل مساعيه في هذا المجال في:
نشر الوعي الديمقراطي والتقدمي: حيث سعى إبراهيم إلى نشر وتعميق الوعي الديمقراطي والتقدمي بين الجماهير الشعبية من خلال كتاباته ومقالاته.
المشاركة في الحركة الوطنية: وذلك باعتبار ما كان له دور فاعل في الحركة الوطنية العراقية، ومشاركته في تأسيس العديد من الجمعيات والمنظمات والأحزاب التي دعت إلى الإصلاح والتغيير، مثل "جماعة الأهالي" و"حزب الاتحاد الوطني"، فضلا عن مساهمته في تأسيس "حزب الشعب"، وهو أحد أوائل الأحزاب اليسارية في العراق. يضاف إلى ذلك تأسيس مطبعة الأهالي التي صدرت عنها جريدة الأهالي والعديد من الكتب. ومساهمته بإصدار مجلة العصر الحديث عام 1937.
كذلك ساهم بتأسيس نقابة عمال السكك الحديدية في العراق، التي لعبت دوراً في إضرابات العمال في ثلاثينيات القرن العشرين.
الدفاع عن الحريات: حيث نادى بحرية الرأي والعقيدة، وكان مهمومًا بإصلاح الأوضاع السياسية والثقافية والاجتماعية في العراق بما يخدم مصالح الشعب.
مساعيه لتأسيس (جمعية مكافحة الأمية) إلى جانب نخبة من المثقفين. فضلا عن دعوته للتعليم والتثقيف الجماهيري كأداة للتحرر الاجتماعي.
سعيه لتحويل النقابات إلى منابر للوعي الطبقي والتنظيم السياسي الديمقراطي.
بايجاز، كان عبد الفتاح إبراهيم مفكرًا رائدًا ساهم بشكل كبير في إرساء أسس علم الاجتماع في العراق، وقدم تحليلات قيّمة للقضايا المجتمعية والسياسية، ولعب دورًا تنويريًا من خلال نشر الوعي وتعزيز الحريات والمشاركة في الحركة الوطنية، فأسهم في بناء وعي اجتماعي جديد في العراق، وسعى إلى ربط المشروع الوطني العراقي بمفاهيم العدالة الاجتماعية والحداثة الفكرية.
خاتمة
رحل عبدالفتاح ابراهيم عام 2003 عن عمر ناهز المئة عام، تاركاً إرثاً كبيراً من المؤلفات والمآثر الفكرية والتوعوية والمواقف السياسية والاجتماعية. لقد شغلته تلك النشاطات بل أخذته بعيداً عن المؤسسة الأكاديمية، حيث لم يشتغل بالتدريس على غرار زملائه أو من تبعه في التخصص مثل علي الوردي وعبدالجليل الطاهر وحاتم الكعبي وشاكر مصطفى سليم. كذلك فإن تلك النشاطات والمواقف، إضافة إلى عدم اندماجه في النخبة الاكاديمية قد ساهمت بتهميشه خصوصاً خلال حقبة العقود الأخيرة من عمره وعمر العراق. فقد توارى عن المشهد الأدبي والإعلامي للأسف حتى وفاته. لكن الأوفياء له انبروا إلى نفض الغبار عن سيرته ومؤلفاته، وساهموا باستذكاره في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من منبر.
د. حميد الهاشمي - أستاذ علم الاجتماع بالجامعة العالمية بلندن، سبق وعمل باحثاً بجامعة ايست، والمركز الوطني للبحوث الاجتماعية بلندن
الهوامش
1- كان الملك فيصل الاول خير مشجع لإنشاء الجامعة وفكرة تأسيس جامعة عراقية بدأت سنة 1921 مع بداية الحكم الوطني ثم سرعان ما اصبحت مطلبا شعبيا . وقد ابدى الملك فيصل اهتماما بالمشروع وهو من امر بتشكيل لجنة تأسيسية لوضع اسسها المالية والعلمية والادارية وكان ذلك في الاول من تشرين الثاني - نوفمبر سنة 1922. وفي 15 اذار 1924 قام الملك فيصل بافتتاح الكلية كما وضع الحجر الاساس لمركز الجامعة التي اطلق عليها اسم (جامعة ال البيت) وقد تقرر ان تضم الجامعة ست كليات (سميت انذاك بالشُعب) وهي الحقوق، والهندسة والفنون والطب والتربية والتعليم فضلا عن الكلية الدينية... وحتى الكلية الدينية تعرضت لانتقادات من مجلس النواب والصحافة وكان ذلك مقدمة الى الغاء الجامعة مع ان نظام الشعبة (الكلية) الدينية صدر سنة 1927 وفي 4 أيار/ مايو 1930 أوقفت التدريسات في الشعبة الدينية ونقلت (كلية الامام الاعظم) الى مكانها السابق على ان تبقى كما كانت قبل دمجها بجامعة ال البيت وأجريت امتحانات طلاب الشعبة الدينية ونال الطلاب شهاداتهم وانتهى الامر. (العلاف، ابراهيم، تاريخ جامعة آل البيت 1924- 1930 في بغداد، الحوار المتمدن، العدد 6841، 15/03/2021:
2- للمزيد، انظر، حميد الهاشمي، مئة عام من مسيرة علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية في العراق، سلسلة مئوية الدولة العراقية (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 2025).
3- عبد الفتاح إبراهيم وحقيقة الفاشية، جريدة المدى، 08/08/2014: عبد الفتاح إبراهيم وحقيقة الفاشية (almadapaper.net)
4- مقدمة في الاجتماع، مطبعة الأهالي، بغداد، 1939. بحجم 223 صفحة.
5- لقد تواصل كاتب هذا المقال شخصياً مع أستاذ علم الاجتماع السعودي الدكتور عبدالرحمن الشقير، وطلب مساعدته في الحصول على نسخة pdf، وقد استجاب مشكوراً وزودنا بها عام 2013، حيث تم نشرها على صفحة منتدى علم الاجتماع العراقي على فيسبوك. للاطلاع انظر:
6- ناهدة عبد الكريم حافظ، "تقويم مناهج البحث في الوطن العربي: بين التراث والمعاصرة، ملف نحو علم اجتماع عربي"، مجلة آفاق عربية، العدد 5، السنة 19، 1992، ص99.
7- أُسست كلية الآداب سنة 1949، تحت اسم كلية الآداب والعلوم، ثم انفصلت عام 1959 لتصبح كليتين (كلية الآداب، وكلية العلوم).
8-للاطلاع على سيرته، أنظر المبحث الخاص بجيل الرواد في الفصل الخامس من كتاب (حميد الهاشمي، مئة عام من مسيرة علم الاجتماع والانثروبولوجيا والخدمة الاجتماعية في العراق، مرجع سابق.
9- للمزيد أنظر: شهاب احمد الحميد، "الأستاذ عبد الفتاح ابراهيم وحرية الرأي والفكر في مجلة العصر الحديث: استعراض لمؤسسة ثقافية وشخصية فكرية"، الحوار المتمدن، العدد 5911، 22/06/2016:
10-عبدالفتاح ابراهيم، تعليق على مذكرة مستقبل التربية والتعليم في العراق، (بغداد: مكتبة بغداد، 1944)، ص 44.
11- المصدر نفسه، ص 44.
12- هكذا وردت، حيث وقتها لم تكن تسمية الخليج العربي شائعة، فضلا عن ان هذا الاستخدام كان شائعا في الخرائط الجغرافية والأدبيات المتعلقة بما فيها العربية. في حين ان الأدبيات العثمانية كانت تسميه (خليج البصرة).
13- الإمارات التي شكلت (دولة الإمارات العربية المتحدة لاحقاً).
14- الألمانية.
15-المقصود الشيخ خزعل الكعبي، أمير المحمرة (مدينة في إقليم الاحوار العربي في جنوب غرب إيران المجاور لجنوب العراق) ويعتبر امتداداً اجتماعياً وثقافياً لجنوب شرق العراق.
16- طالب النقيب (نقيب السادة الأشراف في البصرة) وقد كان أحد المرشحين لعرش العراق إلى جانب كل من الشيخ خزعل الكعبي، والامير فيصل بن الحسين الذي أصبح أول ملك للمملكة العراقية التي أُسست عام 1921.
17- الحرب العالمية الأولى.
18-عبد الفتاح إبراهيم وحقيقة الفاشية، جريدة المدى، 08/08/2014: عبد الفتاح إبراهيم وحقيقة الفاشية (almadapaper.net)
19- يوسف محسن، الفائضون: المثقف، الدولة، المجتمع، (دمشق: دار أمل الجديدة للطباعة والنشر والتوزيع)، 2015، ص 302.
20-علي مرهج، عبد الفتاح ابراهيم والديمقراطية الشعبية، صحيفة المثقف، 18/12/2017: عبد الفتاح ابراهيم والديمقراطية الشعبية (almothaqaf.com)
21- حميد الهاشمي (رده على أسئلة يوسف محسن)، في كتاب الفائضون: المثقف، الدولة، المجتمع، ص 308-309.