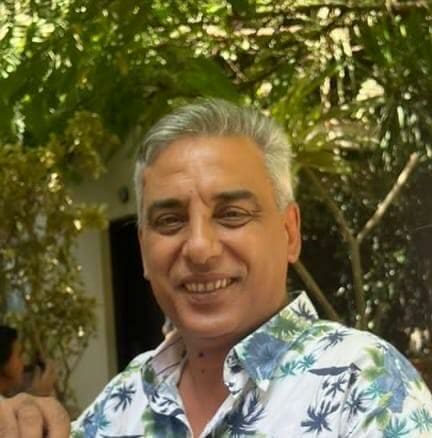
في جلسة هادئة ما قبل الغروب للدكتور طه حسين في منزله بالهرم بالقرب من القاهرة، سأله ابنه مؤنس، لماذا أنت شارد الذهن هكذا يا والدي؟ فأجابه بأنه قد ذهب بعقله ووجدانه ليتجول في أسواق الكوفة والبصرة يستمع إلى المتكلمين وهم يتحاورون مع بعضهم البعض. إنها رحلة ثقافية ومتعة عقلية أختلي بنفسي من خلالها بعيدا عن العصر الحالي.
هكذا كان العراق في الوجدان العربي، لدى المثقف والمواطن العادي في الوقت نفسه، بوصفه أرض الحضارة والثقافة والفكر والتأسيس، تأسيس العقل العربي. وأحسب أن الدبلوماسي العراقي الدكتور حسين الهنداوي انطلق في تأليفه لهذا العمل الهام من ذلك الشعور الذي يسكن كل مَن له علاقة بالثقافة العربية وأصولها، شعور الدور الهام للعراق في المنظومة المعرفية للفكر العربي. فأصدر كتابه بمناسبة مئوية العراق عن دار الشؤون الثقافية العامة بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية عام 2021، وجاء بعنوان "مئة عام من الفلسفة في العراق" كمشروع بحثي استقصائي يقوم على مقاربة بين الحضور الفلسفي ونشأة الدولة العراقية الحديثة. فما بين الدولة والفلسفة يلتقي التعبير العقلاني عن الوعي الذاتي الخاص بشعب ما (وكما في كل الدول الحديثة، اقترن نشوء وتطور النشاط الفلسفي العراقي المعاصر بولادة الدولة العراقية الحديثة في عام 1921، كما لو أن أحدهما ينتظر ولادة الآخر) (ص5). وتلك الدلالة إنما هي حالة متجددة في الأرض العراقية التي كانت مهد الفلسفة في الدولة البابلية، وموطن الفكر الفلسفي أيضا في الدولة العباسية، ما جعل تلك النهضة الفلسفية المعاصرة امتدادا لذلك العقل الفلسفي الذي تأصّل في الوعي العراقي منذ القدم.
- التاريخ والفلسفة
من بين أهم ملامح الحركة الفلسفية العراقية في رأي حسين الهنداوي أنها لم تتبلور بالقدر الكافي، ولم تحقق نفوذا طاغيا، كما لم تتحول التجارب الفلسفية العراقية إلى مدارس متمايزة. ويعلل ذلك بالإرث البعثي الذي أغلق الكثير من نوافذ الحرية التي يحتاج إليها البحث الفلسفي، كما أن مرحلة ما بعد البعث منذ 2003 لم تعالج تلك الإشكالية إلا بشكل جزئي، نظرا لتراجع عقلانية الدولة ذاتها مما أدى لتراجع الثقافة بشكل عام.
ويعود الفكر الفلسفي في العراق إلى الدولة البابلية حتى أنه يؤكد أن (معنى فيلوسوفيا في اللغة الإغريقية ذاته، أي "حب الحكمة" بابلي الأصل كمصطلح وكمضمون، وهو يعني تكوين فكرة عقلانية شاملة عن الوجود الإلهي والإنساني) (ص6). وهذا ما أكد عليه أفلاطون في محاورة "كراتيلوس" حينما أشار إلى أن كلمة "سوفيا" ليست يونانية بل ربما تكون مأخوذة عن ثقافة أجنبية مجاورة. كما أكد المؤرخ الإغريقي ديوجينيس اللائرتي أن فيثاغورث ـ وهو من صكّ هذا المصطلح "فيلوسوفيا" ـ كان متأثرا بدرجة كبيرة بالنظريات والثقافة البابلية، عندما أقام في بابل للدراسة والعلم في الفترة من 525-513 ق.م.
كما أن الدولة العباسية، لا سيما في عهدي هارون الرشيد والمأمون، كانت فترة ازدهار ثقافي وأدبي وعلمي وفلسفي، وشهدت تأسيس بيت الحكمة وازدهار حركة الترجمة، ما سمح للمفكرين والعلماء بتأسيس نهضة حضارية شاملة، وكأن ارتقاء الفلسفة والفكر مرتبطان بصورة مباشرة بوجود دولة قوية ومنفتحة على العلم والمعرفة والتقدم.
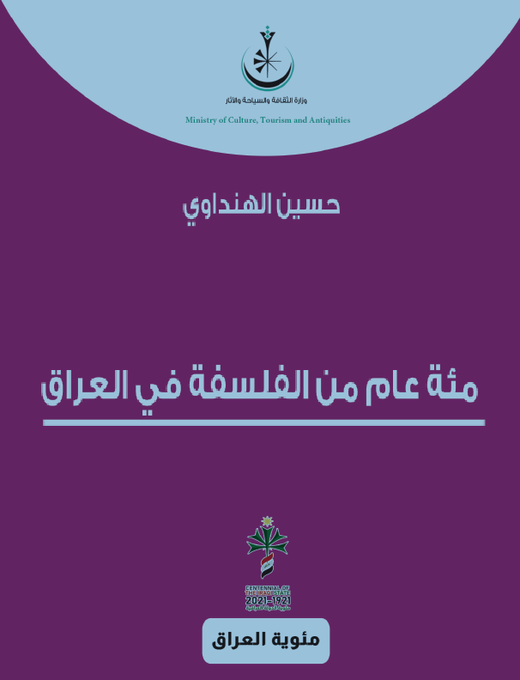
- البدايات والمنطلقات
في الفصل الأول "طلائع التأسيس الفلسفي الجديد" يشير حسين الهنداوي إلى أن التأسيس الفلسفي الحديث في العراق نشأ بعد قرون من التراجع والركود، عبر الاحتكاك بالحياة الثقافية التركية التي كانت بدورها نتيجة لحركة الإصلاح في الحياة السياسية التركية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، عقب إصدار القانون الأساسي عام 1876، الأمر الذي ترك أثره على مجمل النشاط السياسي والثقافي في مركز الإمبراطورية العثمانية وأطرافها.
كما أن وجود حاكم مثل مدحت باشا في بغداد في الفترة من 1869 - 1872، كان له تأثير مباشر على بداية ولادة العراق الحديث نظرا للإصلاحات المهمة التي وضعت العراق على طريق الحداثة والمدنية. فقد شهدت تلك الفترة إصدار جريدة "الزوراء" عام 1869، ووجود مطبعة فرنسية حديثة، وكان لهذه الجريدة دور في بداية بلورة الوعي السياسي والاجتماعي والثقافي عند العراقيين وبداية انفتاحهم على الإنجازات الحديثة، ثم صدرت جريدة ثانية في الموصل عام 1885، وثالثة في البصرة عام 1889. وفي عام 1902 صدرت أول مجلة عراقية في الموصل.
ثم حدث انفتاح أكبر في العراق على خلفية اعلان الدستور العثماني في 1908، ما ساعد على تطور الحياة الثقافية والفكرية. وكان من رموز تلك المرحلة جميل صدقي الزهاوي الذي يعد أول عراقي ينشغل بالفلسفة في العصر الحديث، وكان من القائلين بنظرية التطور، وعمل أستاذا للفلسفة الإسلامية في دار الفنون بإسطنبول، وله إسهامات فلسفية منشورة في عدد من المجلات العربية. وقد اشتبك مع قضايا المجتمع العراقي بعد عودته إلى بغداد، فكتب دفاعا عن المرأة، وأصدر كتابه "الجاذبية وتعليلها" وله كتابات باللغة التركية. ولما عاد إلى بغداد عمل أستاذا في مدرسة الحقوق بها، كما نشر مقالات في مجلتي المقتطف والمؤيد بمصر، وألّف رسالة بعنوان "الدفع العام والظواهر الطبقية والفلكية" نشرت في المقتطف. كما نشر كتاب "الكائنات في الفلسفة" عام 1896.
كان لتراجع الهيمنة العثمانية على البلدان العربية الدور الحاسم في تطور الهويات الوطنية، وبالتالي كان العراق من أهم البلدان التي بدأت فيها الهوية الوطنية في التطور والارتقاء عبر النخب الثقافية التي كانت موجودة في بغداد وبعض المدن العراقية لا سيما لدى طلبة مدرسة الحقوق التي تأسست عام 1908 ثم تأسست جامعة "آل البيت" عام 1922 في عهد الملك فيصل الأول، وكانت تتضمن ست كليات هي: "الدين والطب والهندسة والحقوق والآداب والفنون". ولكنها سرعان ما أغلقت عام 1930 بضغط من سلطة الانتداب.
تأثرت النخبة العراقية بأفكار الأفغاني والكواكبي ومحمد عبده، كما بدأت بوادر الفكر الليبرالي تطرق أبواب العقل العراقي، وكان للمرجع الديني الشيخ محمد كاظم الخرساني دور رائد في مهاجمة الأنظمة المستبدة في العالم الإسلامي والمطالبة بدولة مدنية دستورية في كتابه "تنبيه الأمة وتنزيه الملة" عام 1909 واضعا فيه أسس النظرية الإسلامية الديمقراطية. كما كانت فترة حكم الملك فيصل الأول 1921- 1933 فترة انتشار للفكر الليبرالي، وحرية الصحافة وكتابة الدستور العراقي وتأسيس الأحزاب السياسية.
على جانب آخر، ظهر المفكر العراقي حسين الرحال "1891- .." كرائد للفكر الماركسي في العراق حيث كان له دور كبير في نشر الأفكار الماركسية، والدعوة إلى الجمهورية، والنظام الاشتراكي الاقتصادي وحرية الفكر والتعبير، وكان نشاطه السياسي من الممهدين لثورة العشرين، ويعتبر منظر حلقة ثقافية تحمل اسم "حملة الأفكار الجديدة" التي أصدرت مجلة "الصحيفة" كما كان من أنصار الدفاع عن حقوق المرأة. لقد كانت تجربة "حسين الرحال" إحدى تجليات الفكر الحديث في التربة العراقية، وإن ظلت (مقطوعة اجمالا عن القطاعات الشعبية الواسعة من المجتمع العراقي وما تعانيه من تخلف وأميّة، ومن سيادة الروح والخلافات العشائرية وأدرانها) (ص25).
وعندما تركت الحرب العالمية الثانية أثرا سلبيا على الفكر الإنساني، كان للعراق نصيبه أيضا من هذه النتائج، حيث الشعور بالضياع والقلق والعدمية وعجز الأيديولوجيات الكبرى كالليبرالية والاشتراكية والإسلام السياسي عن تلبية احتياجات البشر الروحية، فظهر المذهب الوجودي في العراق على يد "نهاد التكرلي" وخاصة فلسفة سارتر التي كانت رائجة في تلك الآونة، فقدم شرحا لتلك الفلسفة، وترجمات عن الفكر الفرنسي، ما أسهم في سرعة انتشار الوجودية في العراق خاصة في الأدب والنقد.
وكان الشاعر بلند الحيدري أحد أهم الذين أفرزتهم تلك الحقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية حيث اتسمت تجربته الشعرية بالنزعة الوجودية المتمردة. كما كان متأثرا إلى حد بعيد بالمفكر المصري عبد الرحمن بدوي أثناء وجوده في العراق عام 1950. وإن كان المؤلف يؤكد أن الوجودية في الفكر العربي سابقة على بدوي عن طريق نهاد التكرلي الذي كان من أوائل من طرحوا الفكر الوجودي في المكتبة العربية. كما كان القاص العراقي نزار عباس من النماذج الأدبية التي تأثرت بالوجودية خاصة في مجموعته القصصية "زقاق الفئران" عام 1972.
- الاكاديميا والفلسفة
في الفصل الثاني "أول قسم أكاديمي للفلسفة": افتتحت كليتا الآداب والعلوم في أكتوبر 1949، حيث تكونت كلية الآداب من ثلاثة أقسام هي - اللغة العربية والاجتماعيات "التاريخ والجغرافيا" والفلسفة ـ. وقد انقسمت الدراسة الفلسفية الأكاديمية في العراق إلى أربع مراحل. المرحلة التأسيسية في الفترة من 1949-1959، وكانت تمثل البدايات الأولى بإدارة غير عراقية حيث كان رئيس القسم لبنانيا وهو الدكتور البير نصري نادر.
المرحلة الثانية: 1960- 1970 شهدت وجود الرواد الأوائل مثل (محسن مهدي في فلسفة التاريخ، وياسين خليل في منطق الرياضيات، وحسام الألوسي في فلسفة الكلام، ومصطفى كامل الشبيبي في فلسفة التصوف، وكريم متي في الفلسفة الغربية وصالح الشماع في فلسفة اللغة، وغيرهم) (ص40).
وقد تخرجت أول دفعة من قسم الفلسفة عام 1953 وقام بعضهم بالتدريس سواء في جامعة بغداد أم الموصل بعد ذلك. ومن أمثال هؤلاء جعفر آل ياسين، ومحمد جواد الموسوي مؤسس قسم الفلسفة في جامعة البصرة، ومدني صالح وسهيلة علي جواد بعد استكمال دراساتهم العليا. وكان قد سبقهم الدكتور نوري جعفر كأول عراقي يحصل على الدكتوراه في فلسفة التربية من جامعة أوهايو الأمريكية عام 1949، وتتلمذ على يد جون ديوي. وكانت أطروحته "فلسفة جون ديوي التربوية". ثم كان الدكتور علي الوردي أيضا من أوائل الباحثين الأكاديميين بعد حصوله على الدكتوراه عام 1950 في نظرية المعرفة عند ابن خلدون، وإن تخصص في علم الاجتماع. كما حصل مجموعة مفكرين عراقيين على شهادات علمية في الفلسفة من جامعات كبرى، وعادوا إلى وطنهم ليتأسس بذلك مشروع الفلسفة في الثقافة العراقية على أسس منهجية وعلمية رصينة.
وابتداء من عام 1970 وما بعدها أصبح تدريسيو قسم الفلسفة بجامعة بغداد من العراقيين، وفي اختصاصات مختلفة.. ومنذ العام 1971 سمح (باستحداث دراسة الماجستير لأول مرة، فحصل عدد من الطلبة على هذه الشهادة بعد كتابة رسائل دراسية في موضوعات الفلسفة وتاريخها وأعلام فلسفتها وفق منهج علمي رصين ودقيق وتحت إشراف أساتذة كبار، صار كل واحد منهم يعد بمثابة مرجعية فلسفية مهمة بذاتها، وهنا بدأت هوية القسم تحدد على نحو واضح من خلال ذلك الجهد المتقدم والمزدهر أكثر فأكثر) (ص58).
المرحلة الثالثة كانت منتصف السبعينيات حيث انطفأت جذوة الانطلاقة الكبرى نتيجة للقمع، ليصل ذروته مع اندلاع الحرب العراقية الإيرانية، وما ترتيب على ذلك من انطلاقة حملة اعتقالات واسعة النطاق وإعدامات شملت قادة سياسيين ومثقفين وأدباء وفنانين تعرضوا للاعتقال، وكان من بينهم المفكر محمد باقر الصدر وصباح الدرة ونمير العاني وعزيز السيد جاسم.. الخ، لتنتهي تلك المرحلة بتجفيف منابع الفلسفة والفكر الحر. وهذا ما يفسر (أسباب اضطرار الكثير من كبار أساتذة قسم الفلسفة العراقيين الى الهجرة للعمل في الدول العربية الأخرى أو غيرها، أو تفضيل العمل الحر على التدريس من أجل كسب لقمة العيش، أو ما يماثلها من سبل مشروعة) (ص64).
أما المرحلة الرابعة والأخيرة فبدأت بعد عام 1991 عندما كسر العراقيون حاجز الخوف بعد الانتفاضة الشعبية الواسعة ـ وتزامن مع ذلك إنشاء اقسام للفلسفة في جامعة البصرة عام 1990، وجامعة الكوفة عام 1991، والجامعة المستنصرية عام 1993، وجامعة الموصل عام 94/ 1995، وهكذا توالت الأبحاث والدراسات الأكاديمية الفلسفية وطلاب الفلسفة في تزايد كمي وكيفي وهذه المرحلة مستمرة حتى الآن.
- جيل الرواد من الفلاسفة والمفكرين
في الفصل الثالث "عطاء فلسفي متجدد" يتناول الدكتور حسين الهنداوي أهم أعلام الفلسفة العراقية وإسهاماتهم المتميزة ودورهم في تأصيل التجربة الفلسفية العراقية والعربية. ويقسمهم إلى جيلين، جيل الرواد أو المؤسسين وجيل ما بعد الرواد. جيل الرواد ومن بينهم محسن مهدي، حسام الآلوسي، كامل مصطفى الشبيبي، مدني صالح، ياسين خليل، جعفر آل ياسين، محمد جواد الموسوي، صالح الشماع، كريم متي، عبد الرازق مسلم الماجد.. الخ. والجيل التالي منهم نجم الدين بزركان، عرفان عبد الحميد، موسى الموسوي، ناجي التكريتي، حاتم طالب مشتاق، نمير العاني، عبد الأمير الأعسم، صالح مهدي الهاشم، هذا بالإضافة إلى أساتذة خدموا الفكر الفلسفي من خارج التخصص الفلسفي الأكاديمي أمثال عالم الاجتماع علي الوردي، وأستاذ علم النفس نوري جعفر وأستاذ التربية عبد العزيز البسام، والسيد محمد باقر الصدر، والمفكر هادي العلوي.. وآخرين.
ويذهب المؤلف إلى أن الدكتور محسن مهدي درس الفلسفة في شيكاغو، وحصل على الدكتوراه عام 1954 في رسالة بعنوان "فلسفة ابن خلدون التاريخية: دراسة في الأساس الفلسفي لعلم الثقافة"، وعند عودته إلى بغداد في الفترة ما بين 1955 إلى 1957 عمل محاضرا في كليات القانون والفنون والعلوم بجامعة بغداد، ثم انتقل عام 1957 للعمل أستاذا في جامعة شيكاغو حتى عام 1969، ومنها انتقل إلى جامعة هارفارد ليعمل أستاذا للفكر الإسلامي، وظل فيها حتى تقاعده عام 1996.
وقد تولى عدة وظائف أخرى مثل محاضر زائر في معهد الاستشراق بجامعة فريبورغ بألمانيا، كما تولى منصب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط. ومن أهم مؤلفاته إضافة إلى كتابه عن ابن خلدون، نجد "فلسفة أرسطو عند الفارابي" 1961. "الفارابي في الأدبيات" 1969. "الاستشراق ودراسة الفلسفة الإسلامية" 1990. ومؤلفات أخرى. كما حقق النسخة الأصلية من كتاب "ألف ليلة وليلة".
ويتناول المؤلف أيضا الدكتور حسام الآلوسي وهو واحد من الذين تخرجوا من قسم الفلسفة بجامعة بغداد عام 1956، وابتعث إلى جامعة كمبريدج للحصول على الدكتوراه عام 1965، عن رسالة بعنوان "مشكلة الخلق في الفكر الإسلامي" تحت إشراف المستشرق روزنتال. وعمل أستاذا بجامعة بغداد في قسم الفلسفة منذ العام 1968، ونائبا للجمعية الفلسفية العربية ومقرها الأردن. ومن أهم إصداراته (حوار بين الفلاسفة والمتكلمين) 1967. (الأسرار الخفية في العلوم العقلية) ـ “تحقيق ودراسة. و(من الميثولوجيا إلى الفلسفة أو بواكير الفلسفة قبل طاليس) 1973. و(الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم)، ومؤلفات أخرى على درجة كبيرة من الأهمية.
كما يتناول المؤلف الدور الهام الذي قام به الدكتور ياسين خليل في خدمة الفلسفة العربية، حيث تخرج من قسم الفلسفة ببغداد عام 1957، وحصل على بعثة علمية في جامعة مونستر بألمانيا الغربية للحصول على الدكتوراه عام 1961 في موضوع "مبادئ عامة في التحليل البنيوي للغة" وهو دراسة عن فلسفة رودلف كارناب. ولما عاد إلى بغداد عام 1961 عمل أستاذا للمنطق وفلسفة العلوم، وقدم دراسات مهمة في هذا التخصص خاصة عن الفيلسوف الألماني جوتليب فريجه وفلسفة الرياضيات.
ومن بين من تناولهم المؤلف أيضا من جيل الرواد نجد الدكتور كريم متي فتحي، وهو أحد أساتذة الفلسفة الحديثة في الفكر العربي. حصل على الدكتوراه من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1959. ومن أهم مؤلفاته "الفلسفة الحديثة، عرض نقدي" 1988، و"المنطق الرياضي"، وله إسهامات أيضا في الميتافيزيقا.
وعندما يتناول بعض المساهمين في دعم الفكر الفلسفي نجد في مقدمتهم الدكتور علي الوردي الذي قام بالتدريس في سنواته الأكاديمية الأولى بقسم الفلسفة عام 1949(والوردي لم يعتنق مذهبا فكريا أو فلسفيا رغم تأثره العميق والمعلن ببعض الفلاسفة العرب والمسلمين مثل المعتزلة والغزالي والمتصوفة إلى جانب عبد الرحمن بن خلدون الذي أخذ عنه نظرية الصراع والبداوة والحضارة ليطبقها بطريقته الخاصة المتأثرة أيضا بالمنهج التجريبي لفرانسيس بيكون والمنهج الوضعي لأوغست كونت) (ص 115).
كما يتناول إسهام الدكتور عبد الفتاح إبراهيم مؤسس علم الاجتماع في الدراسات الاجتماعية في العراق والعالم العربي، حيث أصدر عام 1939 "مقدمة في علم الاجتماع" وهي أول دراسة متخصصة في علم الاجتماع في المكتبة العربية.
وعن المرجع الديني محمد باقر الصدر يشير المؤلف إلى أنه (بدأ تكوينه الفلسفي بدراسة مقدمات علم المنطق وعلم الأصول، وألف وهو طالب كتابا يضم اعتراضاته على الكتب المنطقية بعنوان "رسالة في المنطق" وفي مطلع العشرين من عمره بدأ دراسة التأريخ والفلسفة، وتميز عن نظرائه من علماء الدين باختيار النقاش عبر الحجة الفلسفية في العلاقة مع المدارس الفلسفية السائدة ولا سيما الفلسفة الماركسية التي امتلكت خلال القرن الماضي نفوذا أيديولوجيا واسعا في العالم) (ص 139 / 140).
أما الدور الذي قام به المفكر الكبير هادي العلوي، فقد حرص الدكتور حسين الهنداوي على التأكيد عليه، من حيث قدرة هادي العلوي على الجمع بين الفلسفة والتراث، وكذلك دوره من خلال كتاباته المتعددة والمتنوعة في الصحف العراقية والعربية. وقد حاول العلوي إحداث مقاربة بين الماركسية والتراث، كما كتب في التصوف والفكر العربي وقضايا المرأة والفكر السياسي. ومن أهم مؤلفاته (نظرية الحركة الجوهرية عند الشيرازي) و(الرازي فيلسوفا) و(فصول من تاريخ الإسلام السياسي) و(شخصيات غير قلقة في الإسلام).. الخ.
وعن أستاذ الفلسفة الإسلامية في جامعة موسكو الدكتور ميثم الجنابي يشير المؤلف إلى أهم مؤلفاته التي أثرى بها المكتبة العربية والحياة الفكرية في العالم العربي مثل "التآلف اللاهوتي الفلسفي الصوفي "أربعة أجزاء، 1998، و"علم الملل والنحل - ثقافة التقييم والأحكام" 1994، و "الإسلام السياسي في روسيا" 1999، و "الغزالي" 2000، باللغة الروسية، و"الحضارة الإسلامية – روح الاعتدال واليقين" 2006، و"العقلانية واللا عقلانية في الفكر العربي الحديث" 2018، و"فلسفة الفكرة القومية العربية الحديثة" 2018. وغيرها الكثير، ولعل هذا الإسهام الكبير جعله واحدا من أهم المفكرين العرب.
وعن الجيل الحالي من دارسي الفلسفة في العراق، فيحقق المؤلف الحالة التعليمية والأكاديمية الفلسفية في العراق من خلال رصد إحصائي لعدد الدارسين للفلسفة في مرحلة ما بعد الليسانس، مشيرا إلى أنها في تزايد مستمر، وتنوع على مستوى التخصصات الفلسفية المختلفة. وعلى سبيل المثال (في العام الدراسي 20/2021 ما مجموعه 24 تدريسيا نصفهم من السيدات في قسم الفلسفة بجامعة بغداد، من بينهم 21 معهم شهادة الدكتوراه، وثلاثة يحملون الماجستير. أما الجامعة المستنصرية فهناك 33 تدريسيا في قسم الفلسفة من بينهم 32 يحملون شهادة الدكتوراه ومن بينهم ثماني سيدات فقط) (151/152).
- رؤى وتصورات
في الفصل الرابع: (قراءات وآراء) يستعرض المؤلف بعض الآراء التي تناولها رواد الفكر العراقي من خلال أبحاثهم ودراساتهم الأكاديمية، فيبدأ بموقف محسن مهدي الذي تكمن قيمته في أنه ألف كتابا عن ابن خلدون كان ذا أثر بالغ في الكشف عن إبداع المؤسس الأول لعلم العمران البشري. وقد طُبع الكتاب عدة مرات باللغة الإنجليزية، وكذلك بالفارسية، كما أنه خصص قسطا لا بأس به من اهتمامه العلمي بالمعلم الثاني الفارابي وأثره على الفكر الإسلامي والفلسفي، مؤكدا قيمة الفلسفة كعلم لا يقل منهجية عن علم الرياضيات. ولم (يكتفِ المفكر الراحل بالتأكيد على أهمية دراسة الفلسفة الإسلامية والسياسية منها خاصة دراسة علمية، معتبرا إياها بمثابة الطريق الأمثل لفهم أن المطلب الأساسي الذي يواجه مجتمعاتنا ونهضتنا هو تأكيد مكانة العلم ومستقبل الحركة العلمية) (ص 164).
ومحسن مهدي في تقدير المؤلف المرجع الأهم في مجال الدراسات الإسلامية في عالمنا العربي، وذلك نظرا لأنه كان متمكنا أيضا من الفلسفات الإغريقية واليهودية والمسيحية في العصر الوسيط، والفلسفة الحديثة، إلى جانب تخصصه في الفلسفة الإسلامية. بل ويعتبر محسن مهدي هو من وضع القواعد العامة للبحث في الفلسفة الإسلامية العربية. كما يتناول المؤلف التأسيس الفلسفي والتناول المنهجي لمحسن مهدي وقدرته على تأصيل الأفكار الفلسفية نتيجة لقدرته على استيعاب الدرس الفلسفي برمته من المنطق الأرسطي وحتى نهايات الفلسفة الحديثة. كما يعرج المؤلف على مكمن الخلاف بين محسن مهدي وعلي الوردي في الموقف من ابن خلدون. وفي تقييم تجربته الفكرية ومنهجه، حيث يرى مهدي أن ابن خلدون هو تلميذ ابن رشد في المنهج، وتلميذ أرسطو في المنطق، فيما يرى الوردي على خلاف ذلك حيث اعتبر ابن خلدون متصلا أكثر بالعالم الواقعي وليس بالمنطق الأرسطي.
فيما يؤكد المؤلف الدكتور حسين الهنداوي أيضا أن الدكتور حسام الآلوسي إنما كان على وعي كبير بالدراسات البينية في العلوم الإنسانية حيث نجده يخلق أرضية مشتركة بين الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس والأنثروبولوجيا. وفي فلسفة الأخلاق يدعو إلى فلسفة بديلة، مؤكدا أن الأخلاق ظاهرة ينفرد بها الإنسان بسبب اجتماعية السلوك البشري. وفي هذا التصور يرى في كتابه "التطور والنسبية في الأخلاق" 1989، أن تاريخ الأفكار ينقسم إلي خمس مراحل، كل مرحلة منها تعكس نمط العلاقات الاجتماعية السائدة، وهي (مرحلة الحس المشترك، مرحلة التصورات والتفكير التأملي المنتظم، ثم مرحلة إعادة تكوين الخبرة على أساس تجريبي، وهذه المرحلة يعتبرها الآلوسي خاصة بالعصر الحديث. أما المرحلة الخامسة فهي مرحلة مستقبلية تقوم معرفيا على تكوين الخبرة على أساس عقلي) (ص199). وبناء عليه يقرر أن الاخلاق نسبية بالضرورة ولا يمكن أن تكون ثابتة ومستقرة في ظل مجتمعات متغيرة.
وفي الفصل الخامس "نماذج خاصة من كتابات الرواد" يعرض المؤلف لبعض المقالات بأقلام بعض أعلام الفكر الفلسفي العراقي؛ ففي مقال "نحو معرفة جديدة" للدكتور جعفر آل ياسين المنشور في مجلة البيان الكويتية في الأول من نيسان 1977، يؤكد فيه ياسين على تأسيس العلم على معايير ميتافيزيقية، بما يؤدي إلى ضرورة إعادة تعريف مفهوم "المعرفة". وفي مقال "المستشرقون.. واللا تاريخ" للدكتور مدني صالح المنشور في مجلة الآداب في الأول من نيسان 1974 يدعو فيه لتطهير الدراسات العربية من طرائق الاستشراق ومناهج الاستشراق في البحث، وذلك لعدة أسباب منها: (أن الذهنية الاستشراقية ذهنية خالصة، فهي لا شرقية ولا غربية، ولا وسط بين هذا الشرق وذاك الغرب. ومنها لأن هذه الذهنية جامحة في مجال انتحالها صفة وصاية شاملة على الفكر "الأسيو- أفريقي". ومنها لأن المستشرقين ينطلقون بموضوعاتهم من اللا تاريخ إلى اللا تاريخ بلا تصور حضاري يحسون به أنهم ينتمون الى حضارة موضوعاتهم) (ص 246).
وعن مفهوم "التراث العلمي العربي" يعرض المؤلف لمقال الدكتور ياسين خليل المنشور في مجلة "المورد" في الأول من تموز 1989، وفيه يتناول كاتب المقال تلك المصطلحات الثلاثة "التراث - العلم – العربي" ثم يعرض للشروط الواجبة في تناولنا لموضوعات التراث بحيث نفهمها في سياقاتها الاجتماعية والتاريخية والحضارية.
خاتمة
ليس من شك في أن كتاب "مئة عام من الفلسفة في العراق" للدكتور حسين الهنداوي يعد بحثا استقصائيا يكشف من خلاله عن رحلة العقل العراقي الحديث في تخصص الفكر الفلسفي وبعض الدراسات في العلوم الإنسانية الأخرى، حيث انشغل في مؤلفه هذا بجوانب متعددة، منها ما هو متعلق بتأريخ الفلسفة الحديثة في العراق، وما هو متصل ببيان التنوع التخصصي بين رواد الفلسفة العربية من المفكرين العراقيين. وهذا في حد ذاته جهد علمي رصين ودؤوب، ويلبي احتياجا معرفيا في المكتبة العربية التي غاب عنها هذا النوع من المؤلفات التي تحاول رصد تطور نظرية المعرفة المعاصرة. وحسنا فعل الدكتور الهنداوي حينما ربط بين العراق الحديث والفلسفة الحديثة في العراق. مؤكدا أن الحضور السياسي إنما يفتح أبواب الفكر والثقافة والعلم أمام العقول.
محمد دوير - كاتب مصري، دكتوراة في فلسفة العلم.